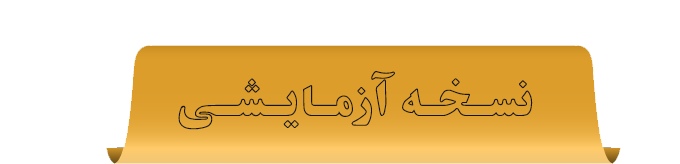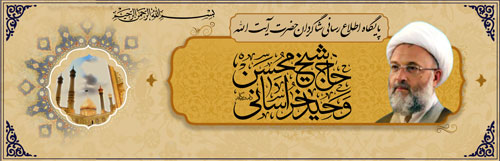ولمعرفة مدى دلالة هذا الإصطلاح في الجرح لابدّ من التعرّض إلى ما ذكره علماء الفنّ في المضمار، فالإضطراب ينقسم إلى قسمين:
القسم الأول: الإضطراب من جهة المذهب والمعتقد
القسم الثاني: الإضطراب من جهة الرواية
أما القسم الأول:
فهو بمعنى التقلّب وعدم الإستقرار في معتقده، (فإنّه التلّون في المذهب، يستقيم تارةً ويعوجّ أخرى)[۱]، وهذا القسم لا ينافي الوثاقة[۲] قطعاً بما يقرب الإتّفاق، حتى عند من اشترط كون الراوي إمامياً، لأنّ الإضطراب في العقيدة لا يُخرجه عن كونه إمامياً.
وشاهده تصريح النجاشي قدس سره وغيره بأنّ مضطرب المذهب قد يكون ثقةً في روايته، كما في الحسين بن أحمد بن المغيرة حيث قالوا فيه (مضطرب المذهب، وكان ثقةً فيما يرويه)[۳]، فيكشف عن عدم مانعية اضطراب مذهب الراوي عن وثاقته عندهم.
أما القسم الثاني وهو الإضطراب من جهة الرواية
وقد نفى البعض وجود قائلٍ بقدحه بعدالة الراوي[۴]، ويكون من أحدىجهتين:
الجهة الأولى: الإضطراب من جهة السند
قال الشهيد الثاني قدس سره: (ويقع في السند بأن يرويه الراوي تارةً عن أبيه، عن جده مثلاً، وتارةً عن جده بلا واسطة، وثالثةً عن ثالث غيرهما)، وقال أيضاً في تعريف الإضطراب: (رواية الراوي عن المعصوم تارةً بالواسطة، وأخرى بدونها)[۵]، وعرفه آخر بأنّه: (ما اختلف راويه – واحداً أو متعدّداً – فيه، متناً أو إسناداً فيروي مرّة بوجه وأخرى على وجه آخَرَ مخالف له)[۶].
وبعبارة مختصرة: الإضطراب في السند هو: أن يبدو إسناد الرواية منافياً الإسنادها بنقلٍ آخر من نفس الراوي – بحذف واسطةٍ أو زيادتها – سواءٌ أمكن الجمع بينهما، فلا تمانع وثاقته وضبطه أم لم يمكن ذلك فيكون الإضطراب مانعاً من الأخذ بهذه الرواية[۷]، خلافاً للشهيد الثاني قدس سره حيث جعل ملازمةً بين صدق الإضطراب وبين عدم امكان الجمع أو الترجيح[۸].
هذا، ولكن السيد الخوئي قدس سره نحى منحىً مختلفاً في تعريف الإضطراب في الحديث، فقال إنّه: (بمعنى عدم الإستقامة في نقل الحديث، فكما أنّه يروي عن الثقة يروي عن غيره، وهذا لا ينافي الوثاقة)[۹].
ولم نعثر على منشأ هذا التعريف في الفنّ، وما ذكره قدس سره أقرب إلى «الضعيف في الحديث» لا «المضطرب».
وكيف كان فإنّ هذا الوصف لا ينافي وثاقة الراوي بوجهٍ من الوجوه، ولا يكون مانعاً من الصحّة والقبول لا عقلاً ولا نقلاً،[۱۰] إلا أن يكون من التخليط – وهو أشدّ من الإضطراب[۱۱] – فيخرج عن الوصف إلى وصف آخر يكون جارحاً لنفس الراوي.
وحتى الشهيد الثاني قدس سره الذي لم يعمل بالحديث المضطرب سنداً، فإنّه وصف الحديث الذي إجتمعت فيه شرائط الصحة بالصحيح وإن كان مضطرباً بسقوط واسطة في السند[۱۲].
ثمّ أنّ منشأ سقوط الواسطة يكون غالباً من النسّاخ – لا من الراوي – ولذا فإنّهم قدّموا أصالة عدم الزيادة في المقام إعتماداً على وثاقة الراوي، وأنّ الزيادة تحتاج إلى مؤونة زائدة بخلاف النقيصة التي قد تنشأ بسبب النسخ. نعم، إن ثبت من القرائن عدم خطأ الناسخ فلابدّ من العمل بالطريقين، لأنّهم كانوا يروون تارةً بلا واسطة وتارةً معها[۱۳] تقويةً للسند.
الجهة الثانية: الإضطراب من جهة المتن
وقد مرّ تعريفه في الإضطراب السندي، وهو أن يروي الرواية بوجهٍ مخالف لروايته الأخرى لنفس الرواية، أي بإختلاف بعض ألفاظ الرواية بين النقلَين، قال الشهيد الثاني قدس سره في الرعاية: (ويقع الإضطراب في المتن دون السند كخبر إعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضاً، أو بالعكس، فرواه في الكافي بالأول[۱۴]، وكذا في التهذيب في كثير من النسخ، وفي بعضها بالثانی[۱۵])[۱۶].
ففي نقل الكافي جعلت الرواية خروج الدم من الجانب الأيمن علامةً للحيض، وخروجه من الأيسر علامةً للقُرحة، بينما وردَ عكس ذلك في رواية التهذيب، مع فرض كون الرواية واحدةً لأنّها وردت بنفس السند في النقلَين.
والمورد الذي ذكره الشهيد الثاني قدس سره هو للمثال لكونه أوضح الأفراد، وإنّما يشمل صورة الزيادة والنقصان أيضاً.
واعتبار هذه الرواية تابعٌ لإمكان الترجيح بينهما – من خلال القرائن الداخلية أو الخارجية – وإن لم يمكن ذلك فتكون الرواية مجملةً ويؤخذ بالقدر الممكن منها ولا تُطرح رأساً، فيجب الأخذ بالرواية المعتبرة صدوراً مهما أمكن، وهذا ما يسمّى بقاعدة الإمكان.
وبما ذكرنا ينفتح المجال لدعوى تعمّد الأئمة علیهم السلام بجعل الإضطراب في عالم الحديث – تقيّةً واتّقاءاً لكي لا يُعرف كون الكتاب منهم علیهم السلام مع ما هو معروف عن بلاغتهم – وذلك لأنّ الإضطراب يمنع من الأخذ بما يكون مُجملاً ولا يُمنع بالأخذ بما هو ظاهر أو متيقن من الحديث، فلا يكون منافياً للغرض.
قال المجلسي الأول قدس سره: (والذي يظهر بعد التتبع والتأمّل؛ أن أكثر الأخبار الواردة عن الجواد والهادي والعسكري صلوات الله عليهم لا يخلو من اضطرابٍ تقيةً أو اتقاءاً، لأنّ أكثرها مكاتبة ويمكن أن يقع في أيدي المخالفين، ولمّا كان أئمتنا علیهم السلام أفصح فصحاء العرب عند المؤالف والمخالف فلو اطلعوا على أمثال أخبارهم كانوا يجزمون بأنّها ليست منهم)[۱۷].
وقد لا يكون الحديث مضطرباً بنفسه، ولكنه يتضمّن مطالب وعلوماً عالية المفاهيم، مما لا تُحتمل عادةً (ولمّا لم يصل إليه أفهامُ بعضٍ ردّه بأنه مضطرب الألفاظ)[۱۸]، مُضافاً إلى الإضطراب الناشيء من سهو النُسّاخ.
ومهما كان سبب الإضطراب في المتن فليس مانعاً من وثاقة الراوي، ولا يُعد قدحاً فيه بوجهٍ من الوجوه.
الخلاصة: أنّ الإضطراب من الأمور ذوات المتعلّق
وقد تبيّن عدم مانعيته من وثاقة الراوي في جميع أقسامه ومتعلقاته.
ولو تنزّلنا وقلنا بقادحية الإضطراب في بعض أقسامه، فكلام النجاشي قدس سره يكون مُجملاً لتردّده بين ما هو مانع من الوثاقة وبين ما ليس بمانعٍ منها، فيسقط كلامه عن الحجيّة لذلك.
لا يُقال: إنّ كلامه مُطلقٌ فيشمل كلّ أقسام الإضطراب.
لأنه يُقال: بأنّ المقسَم إذا كان أمراً انتزاعياً وليس مشتركاً في جميع الأقسام فلا يمكن إرادة العموم منه، فمعنى «مُضطرب في الحديث» مغايرً ومباينً لمعنى «مضطرب في العقيدة»، ولا يمكن إرادتهما بلفظٍ واحدٍ.
والنتيجة: عدم مانعية كلام الشيخ أبي العباس النجاشي قدس سره من وثاقة محمد بن أحمد القلانسي الكوفي الثابتة في البحث الأول بالوجوه المتعددة.
۱ ـ عدّة الرجال (الكاظمي الأعرجي ، ت ١٢٢٧ هـ): ١: ١١٤ / وص٢٥١.
۲ ـ أنظر: الوجيزة: ۱۸۱ رقم ۱۹۲۳ / معجم رجال الحدیث: ۱۹: ۲۷۹ ، و ۳۷۸.
۳ ـ أنظر رجال النجاشي: ٦٨ / رجال إبن الغضائري: ۱۱۸ / خلاصة الأقوال : :۲۱۷ رقم ۱۰.
۴ ـ الملا علي كني الأملي (۱۲۲۰ – ١٣٠٦ هـ) في توضيح المقال في علم الرجال: ٢١١.
۵ ـ منتقى الجمان: ۱: ۹ / وأنظر: الرعاية في علم الدراية: ١٤٧.
۶ ـ الفوائد الرجالية (الكجوري الشيرازي ت ۱۲۹۳ هـ): ۲۰۷.
۷ ـ أنظر: قوانين الأصول: ٤٨٨ / لب اللباب : ۱۲۹ توضيح المقال ( ملا علي كني : ۲۸۲.
۸ ـ أنظر الرعاية في علم الدراية: ١٤٦.
۹ ـ معجم رجال الحديث: ١٥: ٣٤٥.
۱۰ ـ أنظر منتقى الجمان ۱: ۱۲.
۱۱ ـ أنظر: عدة الرجال: ١: ٢٥١.
۱۲ـ حكى ذلك عنه ولده صاحب المعالم قدس سره في منتقى الجمان: ۹:۱ في حاشية منه.
۱۳ ـ أنظر منتقى الجمان ۱: ۱۲.
۱۴ ـ الكافي: ٣: ١٩٤ – ٩٥ ٣ / ونقل في الوافي: ٦ ٤٥٠ أنّ بعض نسخ التهذيب موافقة للكافي.
۱۵ ـ تهذيب الأحكام ١ ٣٨٥ : ح ۸.
۱۶ ـ الرعاية في علم الدراية : ١٤٧ – ١٤٨.
۱۷ ـ حكاه الوحيد البهبهاني عن جده – المجلسي الأول – في تعليقته على منهج المقال: ١٢٤.
۱۸ ـ أنظر: تعليقة على منهج المقال : ١٢٤ في الحسن بن عباس.